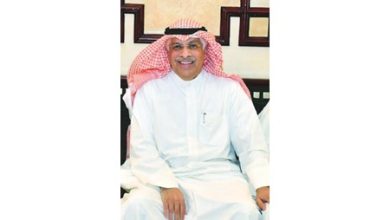الفـزعـة.. بقلم: د. يعقوب يوسف الغنيم

Write a 800–1200 word SEO news article in Arabic.
Topic:
بقلم: د. يعقوب يوسف الغنيم
هذا عنوان يحمل لفظا من ألفاظ اللهجة الكويتية، ومع ذلك فإنه مشابه لفظا ومعنى لمثيله في اللغة العربية الفصحى، وله أكثر من معنى فيهما، ولذا فإنه من المستحسن أن نبدأ بذكر هذه المعاني حتى يسهل علينا الاستمرار في الحديث عنه، ثم بيان الأمر الذي دعانا إلى اختياره لحديثنا هذا. ينطق هذا اللفظ في الفصحى: الفزع، ويأتي على تصريفات مختلفة تختلف معها المعاني. يقول العلامة محمد بن مكرم بن منظور في كتابه «لسان العرب» عن هذا اللفظ:
– الفزع هو الذعر من الشيء، وهو يعني بلفظ الذعر: الخوف الشديد الذي يذهل الإنسان.
– أفزع: بمعنى: أخاف، بأن أدخل الشعور بالخوف إلى قلب غريمه عند النزاع بينهما.
– وفزع إلى القوم: سار إليهم مستغيثا طالبا عونهم على مساعدته في مجابهة ضرر أصابه.
– وأفزع القوم: أغاثهم، والشاهد لهذا المعنى في قول الشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمى:
إذا فزعوا طاروا إلى مستغيثهم
طوال الرماح، لا ضعاف ولا عزل
وقال شاعر آخر:
فقلت لكأس ألجميها فإنما
حللت الكثيب من زرود لأفزعا
وهو يقصد بقوله هذا: إنه إنما جاء إلى هذا المكان، ونزل به بقصد إغاثة من استغاث به هناك.
وقال الراعي النميري:
إذا ما فزعنا أو دعينا لنجدة
لبسن عليهن الحديد المسردا
– ويقال فلان مفزعة إذا كان ممكن يفزع الناس إليه عند الخطر.
– وفي القرآن الكريم ذكر لهذا اللفظ جاء في عدة مواضع، منها ما هو في الآية رقم 87 من سورة النمل في قوله تعالى: (ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين).
وفي الآية رقم 89 من هذه السورة نجد قوله تعالى: (من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون).
وفي الآية رقم 21 ورقم 22 من سورة ص، يقول عز وجل: (وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب (21) إذ دخلوا على داوود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط (22)).
ونجد اللفظ كذلك في الآية رقم 51 من سورة سبأ، والآية رقم 23 منها، كما نجده في الآية رقم 102 من سورة الأنبياء.
– وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسوف الشمس: «فافزعوا إلى الصلاة أي: هبوا إليها، والجأوا إليها واستعينوا بها على دفع هذا الحادث».
– والفزع الإغاثة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار رضي الله عنهم: «إنكم لتكثرون عند الفزع، وتقلون عند الطمع»
وقد فسر مؤلف كتاب «لسان العرب» لفظ الفزع في هذا الحديث الشريف، فقال: «أي تكثرون عندما تطلب منكم الإغاثة، وقد يكون المراد أنكم تكثرون عند فزع الناس إليكم لتغيثوهم».
– والإفزاع الإغاثة.
– يقال: أفزعته لما فزع إلى، أي: أغثته عندما استغاث.
– وفي الحديث الشريف أنه فزع من نومه محمرا وجهه.
(أي: استيقظ فجأة)
– ومن معاني الفزع: الخوف.
– وقالت أم المؤمنين السيدة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: «مالي لا أراك فزعت لأبي بكر وعمر، كما فزعت لعثمان»؟
فقال: عثمان رجل حيي (شديد الحياء)، ولفظ فزعت هنا تريد بها، رضي الله عنها، تأهبت، وتحركت لاستقباله، وجواب الرسول الكريم لها يدل على أنه يريد أن يزيل عن سيدنا عثمان رضي الله عنه هذا الحياء عندما يتحدث إليه.
وفي الحديث الشريف أنه صلى الله عليه وسلم فزع من نومه – أي انتبه فجأة – وجاء في حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم، كان نائماً فاستيقظ وقال لمن كان عنده:
– ألا أفزعتموني؟
بمعنى: نبهتموني، أو أيقظتموني.
– وفزيع اسم، هكذا قال ابن منظور، وهذا الاسم ما زال دارجا إلى يومنا هذا، وفي الكويت أسرة كريمة تحمله.
– وقال أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء: «والمفزع يكون جبانا ويكون شجاعا، فمن جعله شجاعا قال له أنت مفزع الناس، والفزع – أيضا – الإغاثة».
– واستمر مؤلف كتاب «لسان العرب» قائلا: والإفزاع: الإغاثة، والإفزاع: الإخافة، ومن معاني (فزع) الانتباه من النوم فجأة لسبب ما كما جاء في الحديث السابق.
– ويقال فزعت لمجيء فلان، إذا تأهبت له متحولا من حال إلى حال، كما ينتقل أحدهم من النوم إلى اليقظة، وهذا معناه أن المرء ينتبه فجأة ثم ينهض.
وفي كتاب «المفضليات» الذي جمع فيه مؤلفه: المفضل الضبي ثلاثين ومائة قصيدة من عيون القصائد التي قالها شعراء الجاهلية وصدر الإسلام، وردت قصيدة قالها شاعر اسمه: الكلحبة العرني، والكلحبة هو لقبه الذي عرف به واشتهر، ولكن اسمه هو: هبيرة، وكانت قصيدته هي الثانية في مجموعة المفضل الضبي، وقد تحدث الشاعر فيها عن حادث جرى لأسرته، فهبت له الأسرة بأسرها وكان معها، للانتقام والثأر من الفاعل، ومما نريد الإشارة إليه هو لفظ (فزعة) في قوله:
فقلت لكأس ألجميها وإنما
نزلنا الكثيب من زرود لنفزعا
وقد مر بنا ذكر هذا البيت، وهذا موضع مناسب لشرحه.
كاس: اسم ابنته، يدعوها إلى وضع اللجام في مكانه من فم الفرس حفظا لها، وزرود: اسم مكان، ونفزع هنا بمعنى: نغيث. يقول إنه هو ومن معه إنما خرجوا من أجل إغاثة المعتدى عليهم.
وفي مجموعة المفضليات – أيضا – قصيدة قالها الشاعر زبّان بن سيار، جاء فيها البيت التالي:
وإذا فزعت غدت ببزي نهدة
جرداء مشرفة القذال دؤول
وفزعت هنا بمعنى: قمت سريعا بالإغاثة لمن دعاني إليها، وقوله: غدت ببزي نهدة معناه: جرت بسلاحي فرس ضخمة، قصيرة الشعر، طويلة العنق، ثقيلة في مشيها بسبب ما تحمله مني ومن سلاحي.
٭ ٭ ٭
هذا الذي مر بنا ذكره هو بيان معنى لفظ (فزع) بمختلف أوضاعه في اللغة العربية الفصحى، ولكننا هنا سننتقل إلى الحديث عن جانب آخر هو بيان أوضاع هذا اللفظ في لهجتنا العامية التي نشير دائما إلى أنها ابنة للفصحى تستمد معظم ألفاظها مما كان ينطق به الآباء الأوائل من العرب.
ومما يذكر في هذا الشأن أننا نقول:
– فزع من نومه: إذا هب منه بصورة مفاجئة.
– فزع مما رآه: أصابته رهبة بسبب ذلك.
– فزع لصاحبه إذا قام إلى مساعدته على اجتياز إحدى المشكلات التي ألمت به.
– ونقول فزعة، ومعناها قيام مجموعة من الناس بمعاونة من استعان بهم بغية إغاثته وإعانته على دفع مشكلة حلت به أو كارثة أصابته لا يستطيع أن يتجاوزها منفرا.
٭ ٭ ٭
وآكَدُ مثال في تاريخ الإسلام، وربما كان هذا في تاريخ الدنيا كلها هو الفزعة التي قام بها الخليفة العباسي المعتصم، الذي كان ثامن الخلفاء العباسيين، وكانت مدة ولايته منذ سنة 833م حتى سنة 842م.
ففي سنة من سنوات توليه الخلافة، وبالتحديد فقد كان ذلك في سنة 837م هاجم الروم مدينة على حدود الدولة الإسلامية متاخمة لهم. وقد آذوا أهلها وشردوهم وقتلوا وأسروا عددا كبيرا منهم. وقد وقفت واحدة من النساء المقهورات صارخة ومستنجدة بالخليفة قائلة: وا معتصماه.. فانتقل دوي ندائها التي عبرت به عن هول ما رأت حتى بلغ أسماع المعتصم، فانفعل بذلك انفعالا شديدا. وعزم – فورا – على تلبية النداء، وتأديب المعتدين، وذلك بالفزعة للبلدة المنكوبة التي تضرر سكانها، وكان همه – يومذاك – معاقبة الذين اعتبرهم قد ألحقوا الأذى بالدولة الإسلامية كلها لا على قرية حدودية بعيدة عن العاصمة وفي قمة انفعاله بذلك، أمر بالاستعداد للحرب. ثم سار إلى هدفه، فأنقذ القرية الحدودية، ودمر للروم قرية من قراهم هي: عمورية.
واستولى عليها من أيدي أعدائه، بعد أن أذاقهم مرارة الهزيمة.
ومما يذكر أن الفلكيين قد زعموا له أن وقت خروجه غير ملائم لما توحي به الكواكب والكتب المتعلقة بالأدلة على مساراتها، وأن من الأفضل تأجيل المعركة إلى وقت آخر. ولكن المعتصم لم يستمع إليهم، منكرا كل ما قالوه، فخرج إلى القتال، ثم فاز بما يريد، وفي هذا يقول الشاعر أبو تمام (حبيب بن أوس):
السيف أصدق أنباء من الكتب
في حده الحد بين الجد واللعب
بيض الصفائح لا سود الصحائف في
متونهن جلاء الشك والريب
والعلم في شهب الأرماح لامعة
بين الخميسين لا في السبعة الشهب
أين الرواية بل أين النجوم وما
صاغوه من زخرف فيها ومن كذب
إلى أن قال:
فتح الفتوح تعالى أن يحيط به
نظم من الشعر أو نثر من الخطب
فتح تفتح أبواب السماء له
وتبرز الأرض في أثوابها القشب
يا يوم وقعة عمورية انصرفت
منك المنى حفلا معسولة الحلب
أبقيت جد بني الإسلام في صعد
والمشركين ودار الشرك في صبب
وخيم في العصر الحديث على الأمة الإسلامية هم ثقيل وبالتحديد في سنة 1948م بعد أن احتلت إسرائيل فلسطين، وقتلت عددا كبيرا من أهلها، فاستثار هذا الحدث كافة بني الإسلام، ومن هؤلاء الشاعر السوري عمر أبو ريشة الذي قال قصيدة لا تزال تتردد على الألسنة بسبب جمالها وإتقانها وبسبب دلالتها على الأمر الذي حل بنا جميعا بفقدان فلسطين. وهذا هو مطلعها:
أمتي هل لك بين الأمم
منبر للسيف أو للقلم
أتلقاك وطرفي مطرق
خجلا من أمسك المنصرم
ويكاد الدمع يهمي عابثا
ببقايا كبرياء الألم
ومنها قوله:
ودعي القادة في أهوائها
تتفانى في خسيس المغنم
رب وا معتصماه انطلقت
ملء أفواه الصبايا اليتم
لامست أسماعهم لكنها
لم تلامس نخوة المعتصم
٭ ٭ ٭
ونعود هنا إلى الحديث عن لفظ (الفزعة)، وسيكون ما نحن في السبيل إلى ذكره عن استعمال هذا اللفظ في لهجتنا الكويتية، فنجد أن استعماله عندنا قريب من استعمال السابقين من العرب له، وذلك إما أن يكون بتطابق تام في المعنى، وإما أن يكون بتطابق في وصفه لأعمال سنذكر بعضها.
يقال هذا اللفظ في اللهجة الكويتية، ويقصد به أن يهب واحد أو جماعة من الناس لتلبية نداء مستجير، أو طالب نجدة، أو محتاج، يقال: فلان فزع لجاره إذا أسرع إلى مساعدته في أمر من الأمور التي تحل به، فيكون فيها خطر عليه. ولكننا نقول – أيضا – فزع فلان من نومه، ونقول: فزع، بمعنى أصابه الخوف، ومن طباع أبناء الكويت الأصيلة فيهم، كثير من الصفات المؤدية إلى أعمال الخير، والتي تنتج عنها أعمال الفزعة، ومن أجل ذلك فإنهم يرددون – دائما – عبارة تتعلق بذلك ونصها: «قوم تعاونوا ما ذلوا»، وهم يطبقون في حياتهم ما يرمى إليه الحديث الشريف: «الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه».
ووصف الشيخ يوسف بن عيسى القناعي الكويتيين في كتابه: «صفحات من تاريخ الكويت» الصادر في سنة 1946م، فقال: «لأهل الكويت مناقب يمتازون بها عن غيرهم، وإن كانت بلاد الله لا تخلو من الطيبين رجال الفضل والإحسان».
وذكر بعضا من صفاتهم فقال:
1- مساعدات بعضهم لبعض متواصلة للمنكوبين والمعوزين من الفقراء واليتامى والمساكين وأبناء السبيل.
2- لا تجد في الكويتي كبرياء، ولا يحتقر أي واحد منهم الناس مهما كانت منزلته من الرفعة.
ويكفينا هذا للاستدلال على ما نريد التعبير عنه، ولقد شهد تاريخ الكويت أمثلة كثيرة لما أشار إليه الشيخ يوسف بن عيسى، وكلها تشير إلى ما كان يقوم به المواطنون الكويتيون من أعمال تدل على حبهم لوطنهم ورغبتهم في أن يعيش هذا الوطن حرا مستقلا، ينعم أهله بالرخاء وتسود بينهم المودة، ويعم فيهم التكافل والتآلف.
ومما سجله التاريخ هو فزعة المواطنين جميعا إلى بناء السور الثالث، حينما دعاهم إلى هذا العمل الشيخ سالم المبارك الصباح في سنة 1920م. وقد قرر الشيخ إقامة هذا السور دفعا لأية شرور قد تتعرض لها الكويت، وحماية لها من ذلك.
وقد كان بناء هذا السور ملحمة وطنية عاشها أهل الكويت جميعا، وشارك فيها كل من يقدر على المساعدة حتى رأينا هذا السور رمزا للعمل الوطني المخلص ودليلا على الفزعة الشعبية من أجله.
٭ ٭ ٭
ليس ما ذكرته عن بناء السور هو الدليل الوحيد على فزعة الكويتيين لصالح وطنهم، ومن أجل حمايته من كل طامع، وإن كان هذا العمل دليلا ساطعا على ذلك، لأن تعاون الكويتيين فيما بينهم كان أمرا قد طبعوا عليه منذ الأجيال الأولى منهم وما زال ممتدا بهم إلى يومنا هذا، وإن أنس شيئا فإنني لا أنسى ليلة من ليالي النصف الثاني لسنة 1961م حين خرج أهل الكويت لحماية بلادهم بعد ادعاءات قاسم العراق، واذكر أنني كنت ضمن الخارجين في تلك الليلة.
وشاهدت فوجا من أبناء هذا الوطن يتقدمهم المرحوم بإذن الله خالد اليوسف المرزوق وهو يحمل على كتفه رشاشا حربيا مستعدا به لأي طارئ.
ولقد تعمدت ذكر تاريخ صدور كتاب الشيخ يوسف بن عيسى: «صفحات من تاريخ الكويت» وهو سنة 1946م من أجل أن أبين أن تعاون المواطنين الكويتيين كان قديما وكانت حياتهم تسير على وتيرة من حسن التعامل، وصدق المودة منذ ذلك الوقت بل ومن قبله. وقد صرنا نشاهد أبناء البلاد المنتمين إلى الفترة التي تحدث عنها الشيخ الكريم، وهم المنحدرون عن أجداد وآباء كانوا على صفاتهم فساروا على آثارهم، ولذلك فإنا نرى ما يلي:
1- مرت بالكويت أحداث مست عددا كبيرا من الأهالي كان من أشدها مرض الطاعون الذي فتك بكثيرين من الناس في سنة 1930م، وقد شهدت البلاد خلال فترة وجود الوباء أمورا آلمت الجميع.
وبعد انتهاء هذا الوباء، فزع الناس جميعا إلى مكافحة آثاره السيئة، وعاون بعضهم بعضا على اجتياز المحنة. ولقد كانت كارثة كبيرة، وكانت نتائجها لا تحتمل، ولكن الكويتيين (تفازعوا) كما نقول في لهجتنا، لكي يجعلوا الحياة في وطنهم تعود إلى طبيعتها بأسرع ما يكون.
2- سنة الهيلق، وقد ذكرها الشيخ يوسف بن عيسى في المرجع السابق ذكره فقال إنه في هذه السنة قدمت إلى الكويت أعداد كبيرة من الناس من أهل فارس أصابتهم مجاعة في بلدهم وذلك بين سنتي 1868م و1871م، يقول: «وقد قام أهل الكويت بالأعمال الجليلة من إطعام المساكين، وإنقاذهم من التهلكة، حتى من الله عليهم بالفرج».
3- وفي سنة 1871م، غرقت سفن كويتية كثيرة في الهند بسبب طوفان عظيم حدث هناك، وقد تعاون المقتدرون من أهل الكويت، حتى أعانوا المتضررين بهذا الحادث، وأصلحوا أمرهم.
4- وحدث في سنة 1873م مطر عظيم في الكويت صحبه ريح عاصف، وارتفاع في أمواج البحر، فخربت منازل، وارتطمت السفن مع بعضها، وكان الضرر نتيجة لذلك كبيرا، ولم يتخلف قادر من أهل البلاد عن المساعدة، والسعي إلى تجاوز البلاد وأهلها هذه الشدة التي حلت وأضرت بالبلاد والعباد.
وفيما بعد ذلك من السنين، وكانت الأمور عندنا قد تغيرت وصارت في الكويت دوائر حكومية تتولى كل الخدمات الضرورية التي يحتاج إليها الناس، وكانت هذه الدوائر تؤدي دورها في الحالات التي كانت تجابه بها الأحداث المشابهة لما جرى في الماضي، ولكن الناس استمروا على ما كانوا عليه وكأنهم قوم صناعتهم: الفزعة، إذ كانوا لا يتأخرون عن القيام بها، ولذا فإننا كنا نرى منهم أناسا قد نذروا أنفسهم لنقل المرضى العاجزين إلى مراكز العلاج المتاحة آنذاك، والقيام بكل ما يخفف الأضرار.
وفي ذلك الوقت كان الناس يهتمون بالالتقاء على تجهيز الموتى ونقلهم إلى مقرهم الأخير مشيا على الأقدام بأعداد تتكاثر كلما جد بهم السير. وهم قد قاموا بذلك رغبة في نيل الأجر من الله، عز وجل، واتباعا لعادة آبائهم في الفزعة لكل من يحتاج إليها.
ومن مظاهر الفزعة إطفاء الحرائق في البيوت والمحلات التجارية والسفن، وقد شاهدت نماذج كان الناس فيها يبذلون جهودهم من أجل الإطفاء والإنقاذ، دون أن يدعوهم أحد إلى ذلك. وأذكر سفينة احترقت في الفرضة بالقرب من المدرسة الأحمدية حين كنت أدرس بها في أربعينيات القرن الماضي، وكان المتطوعون يلتفون حول هذه السفينة من كل جانب وهم بأعداد كبيرة، ولم يغادروا المكان حتى أنجزوا مهمتهم.
وفي الفترة المتأخرة من حياتنا شهدنا أمرين مهمين صارا علامة من علامات تاريخ وطننا أولهما ادعاءات عبدالكريم قاسم الكاذبة التي يرفضها التاريخ، وتأباها الحقوق الوطنية الثابتة للكويت وقيادتها، وأهلها. فيوم صدرت تلك الادعاءات خرج المواطنون وهم يعبرون عن رفضهم لهذا الادعاء وسخطهم على المدعي، ويقدمون أنفسهم فداء للوطن، وينادون الأمير قائلين: يا بوسالم عطنا سلاح. وهذا غير ما قاموا به في الليالي العديدة من حراسة للوطن، يستوى في ذلك كبار السن والشبان، وكانت روح الفزعة للوطن هي التي تحرك كل هؤلاء.
وفي اليوم الثاني من شهر أغسطس لسنة 1990م جرى في الكويت حادث خطير كان وقعه أشد من سابقه، وقد جاء من مصدر الخطر الأول، حيث هجم العراق على الكويت واحتلها وشرد أهلها، وأتلف كل ما في البلاد من معالم ومصانع، وأحرق آبار النفط، وأخلى المخازن والدوائر الحكومية والملاعب وغيرها من كل محتوياتها وانتهبها وجرى كل ذلك بأيدي المحتلين الذين لم يراعوا حرمة المنازل ولا الدين أو الإنسانية.
وفي هذا الوقت اندفعت نزعة الفزعة عند الكويتيين، فقاموا بالواجب تجاه وطنهم، سواء من كان منهم في الداخل أم في الخارج. فقد وجدنا في الداخل صورا من التكاتف لا توصف، إذ تعاون الكل على اجتياز المحنة بكل الطرق حتى لقد تقاسموا القوت بينهم، وتولى الشباب العمل في المخابز، وكنس الطرق، ومساعدة المتضررين بقدر ما لديهم من إمكانات. وهذا بخلاف ما كان يقوم به المكافحون بسلاحهم المحدود الذي كان يخيف الأعداء المحتلين على الرغم من محدوديته وهو أمر نراه في تصرفاتهم. فقد عملوا لجهد هؤلاء الرجال ألف حساب.
٭ ٭ ٭
هذه هي الفزعة، وهكذا يفهمها ويقوم بها أبناء الكويت عند الملمات التي يقفون عند وقوعها وقفة رجل واحد، حتى لقد خطر في البال أن الفزعة لفظ كويتي بحت وأن ما يصنع باسمها وقف على الكويتيين لولا ما رأيناه في القرآن الكريم، والحديث الشريف وكتب اللغة العربية.
ولا يسعنا هنا إلا أن نهتف قائلين:
يا بلادي أنت رمز الكبرياء
أنت رمز العز عنوان الإباء
قد علا صوتك في كل سماء
فتخطى الشعب ألوان العناء
ومضى للمجد مرفوع اللواء
يا بلادي..
تصحيح
«في مقال: «من الفنون الشعبية» الذي نشر بالعدد الصادر في يوم الجمعة الموافق الرابع عشر من شهر نوفمبر؛ ورد اسم الشاعر منصور بن جليعيد الرشيدي نقلا عن كتاب «الفنون الشعبية» للأستاذ عبدالله عبدالعزيز الدويش الذي أورد له أبياتا تنشد في حفلات العرضة، وقد ورد الاسم في المقال ذاته مرة أخرى كما يلي: منصور بن جليعيد الشمري. والاسم الصحيح هو الأول. لذا وجب الاعتذار».
Output: HTML only (no Markdown/backticks). Use
,
,
. No title. Return only the article body HTML.
Style/structure:
– Inverted pyramid: Who/What/When/Where in first two paragraphs; then Why/How and implications.
– Intro 50–80 words and must include the main keyword.
– Use
section headings (at least one includes the main keyword);
for sub-points if needed.
– Short 2–4 sentence paragraphs with natural transitions (However, Additionally, Meanwhile, In contrast…).
– Tone: clear, neutral, AP-style, active voice; no hype/filler.
– Short 2–4 sentence paragraphs with natural transitions (However, Additionally, Meanwhile, In contrast…).
– Tone: clear, neutral, AP-style, active voice; no hype/filler.
SEO:
– Pick ONE main keyword; use it in the first paragraph, in one
, and 4–6 times total (~1%).
– Add 2–3 related secondary keywords naturally.
Originality/accuracy:
– Synthesize and add neutral background; do not mirror source phrasing.
– Attribute claims (“according to…”, “the ministry said…”). No invented quotes/data.
– If uncertain, hedge (“the report indicates…”) rather than guessing.
Conclusion:
– Brief forward-looking wrap that states the next expected step, deadline, or decision; note uncertainties and what to watch. Factual and neutral; no promotional calls to action.
Constraints:
– No lists unless they add clear value.
– No inline styles or tags beyond
,
,
, .
– Must be plagiarism-free and WordPress-ready.
– Article MUST be in Arabic.
– Must be plagiarism-free and WordPress-ready.
– Article MUST be in Arabic.