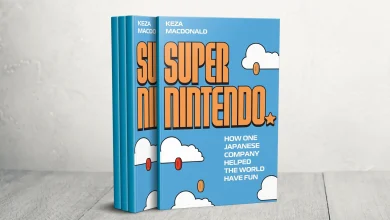ولدت بإيران ودرست التصوف وكتبت عن صدام الثقافات.. طريق دوريس ليسينغ إلى نوبل للآداب

في ذلك الصباح، كانت دوريس ليسينغ عائدة من رحلة التسوق اليومية، التي ظلت تحرص على القيام بها، كل يوم، على الرغم من سنوات عمرها المتأخرة.
وما إن توقفت بها سيارة التاكسي، حتى اتجهت نحو السلم الخارجي أمام منزلها، وجلست تنتظر السائق، الذي كان عليه أن يعيد لها المتبقي من الأجرة، قبل أن تغيب في الصمت تمامًا، ثم تنشغل بالسلة التي تضع فيها الخضراوات.
فجأة، انتبهت ليسينغ إلى الحشد الذي راح يحيط بها، والذي كان يضم مجموعة من العاملين في الصحف، تزاحموا في ذلك الوقت أمام بيتها. وما إن رآها أحدهم، حتى تقدم نحوها، وراح يسأل: هل نما إليك خبر حصولك على جائزة نوبل؟
لم تكن وقتها قد عرفت الخبر، وكان أن تركت الصحفيين ومرافقيهم من المصورين، والتفتت الى سائق السيارة، وراحت تسأل: ما الذي يفعله هؤلاء أمام بيتها؟ رد أحدهم قائلا: يبدو أنك لم تسمعي جيدًا ما قلت، لقد فزت بنوبل.
ردت بصوت مسموع ” أوه.. يا إلهي”. ثم ظلت جالسة في مكانها وأخذت تقلب بيدها في سلة التسوق، ثم طلبت من ابنها أن يدخل المنزل ليُحضر لها كوبا من الماء.
بعدها، سألت الصحفيين عما يريدون منها أن تفعل، وهي تسمع خبر فوزها بجائزة كانت تستحقها منذ 30 عاما.
حيثيات
في اليوم التالي، طرحت السؤال نفسه، حين أجرت معها لجنة نوبل مقابلة صحفية، قالت فيها إنها لم تتفاجأ على الإطلاق بفوزها، لأنها تظن أنها تستحقها.
واستطردت تقول، إن هذا الأمر لن يُحدث أي تغيير في حياتها، وإنها سوف تذهب كالعادة كل صباح، لتتسوق بنفسها، لأنها تتمتع بمهارة في اختيار أنواع الخضراوات.
كانت ليسينغ قد بلغت الـ87 من عمرها، وكان اسمها قد ابتعد كثيرا عن البروز في ذلك العقد، بعد أن كانت قد فرضت نفسها بقوة في التسعينيات من القرن الماضي، وظهر اسمها أكثر من مرة كمرشحة لجائزة نوبل.
في حيثيات الفوز ذكر بيان الجائزة أن الروائية البريطانية دوريس ليسينغ ألهمت جيلا من الأديبات، بما كتبت عن تجربة المرأة، وأنها بقوة رؤيتها، أخضعت حضارة منقسمة على نفسها للفحص والتدقيق. لكن قبل نوبل، كانت ليسينغ قد حازت العديد من الجوائز الأوروبية الكبري، ففي عام 1954 نالت جائزة سومرست موغهام، وفي عام 1976 فازت بجائزة الروائيين الأجانب، ولم ينتهِ عام 1981 إلا وقد حصدت جائرة الأدب الأوروبي، وفي العام التالي 1982، نالت ليسينغ جائزة شكسبير، أما في العام 1987 فقد حازت جائزة باليرمو، كما نالت في هذا العام 1987 جائزة الرواية الدولية، قبل أن تستحوذ على جائزة جايمس بلاك في عام 1995، وفي العام ذاته تنال جائزة لوس أنجلوس تايمز، ثم تفوز بجائزة القلم الذهبي في العام 2002.
لأجل ذلك، وجدت ليسينغ نفسها تقول للصحفيين الذين كانوا قد احتشدوا أمام منزلها في العاصمة البريطانية لندن وراحوا يبلغونها بأنها فازت بنوبل “لقد فزت بكل الجوائز الأوروبية. لذلك أنا سعيدة، لأني فزت بها كلها.. إنها هي الورقة الرابحة”
بدايات صعبة
ولدت ليسينغ في عام 1919 في كرمنشاه بإيران، وكان والدها كاتبا في أحد المصارف، أما والدتها فكانت ممرضة. وقد دفعت أحلام الثراء السريع تلك العائلة إلى الانتقال إلى روديسيا (زيمبابوي وزامبيا حاليا)، لكن ليسينغ عاشت هناك “طفولة مؤلمة” كما وصفتها. حتى إنها حين بلغت الـ15 من عمرها، هربت من منزل العائلة، كما أنها لم تُنهِ تعليمها بعد ذلك، ولجأت إلى تثقيف نفسها عبر الانغماس في القراءة.

حتى إنها في النهاية، لم تترك نوعا أدبيا إلا وطرقته، ليسفر ذلك في النهاية عن حصيلة تضم نحو 60 كتابا في القصة القصيرة والرواية القصيرة والرواية والشعر والنقد والمسرح بل وحتى في الأوبرا. وقد اعتمدت كتبها غير القصصية، على التزامها الجاد بالشؤون السياسية والاجتماعية التي عبرت فيها عن الصدام بين الثقافات، والظلم الفادح الناجم عن التفرقة العرقية، والصراع بين عناصر متضاربة داخل شخصية الفرد، والانقسام بين ضمير الفرد ومصلحة الجماعة.
أما في قصصها القصيرة ورواياتها التي أصدرتها في العقد السادس من القرن العشرين والتي كانت تدور في أفريقيا، فقد تناولت فيها طرد المستعمرين البيض للسود من أراضيهم والاستيلاء على ممتلكاتهم، كما فضحت العقم الذي كشفت عنه في ثقافة البيض في أفريقيا.
وقد اتسم مشروع دوريس ليسينغ برؤية سوداوية للعالم، وفي أغلب رواياتها قامت برسم عالم على وشك التحلل، تواجه شخصياته مصيرا مجهولا، وحالة ضاغطة تسيطر عليها الفوضى. الأمر الذي يمكن من خلاله، العثور على ملامح لحياة الكاتبة نفسها، وكأن هذه الحياة هي مادة أعمالها، وهو ما كتبته وأعادت كتابته بغزارة، مع قدرة على خلق الشخصيات ورسم ملامحها الدقيقة.

معرفة عميقة
صدرت رواية “العشب يغني” عام 1950 كأولى روايات ليسينغ، لتتمحور حول علاقة زوجة مزارع أبيض وخادمها الأسود، فيما حققت لها رواية “المفكرة الذهبية” الصادرة عام 1962 الشهرة، بعد أن تناولت فيها بشكل واضح، وجهة نظر القرن العشرين، حول العلاقة بين الرجل والمرأة.
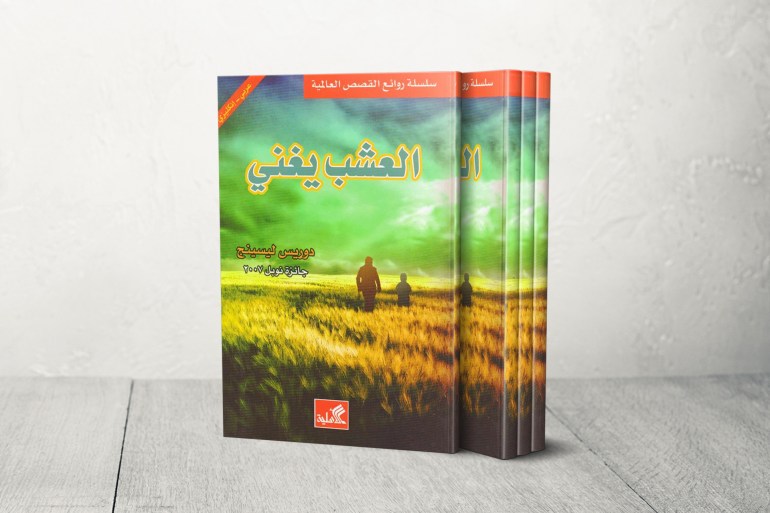
أما في السبعينيات والثمانينيات، فقد بلغت ليسينغ مرحلة متقدمة من التصوف والتأمل عبرت عنها في رواياتها “بيان موجز لمنحدر إلى سقر”، وفي “مذكرات من نجا”، و”سهيل في آرغوس”. الأمر الذي أفضى بها إلى التوقف عن الكتابة لبضع سنوات، قررت فيها الدراسة على يد رجال تصوف مسلمين.

وقد تأثرت بهذه الأجواء في “رباعية الفضاء الميتافيزيقية” التي نشرتها فيما بعد. ومن بعدها سعت ليسينغ إلى تعميق معرفتها بالروح الإنسانية، ولم تتوقف عند حدودها المعرفية الأولى، وواصلت البحث والتنقيب، وكان التصوف الإسلامي أحد تلك العوالم التي جالت فيها.
ولم تتوقف ليسينغ عند هذا الحد، فقد راحت تكتب سلسلة روايات تنتمي إلى الخيال العلمي، بدأتها برواية “شيكاستا” وقدمت فيها رؤيتها القلقة لمصير كوكب الأرض من خلال قصة كوكب مُواز، أو شبيه بالأرض، يتطور من الازدهار إلى التدمير الذاتي تحت رعاية 3 إمبراطوريات، وقد طرحت في هذه السلسلة كل تساؤلاتها عبر دمج الخيال بالواقع، فتتناول علم الوراثة والحرب النووية وما بعد الاستعمار، والعنصرية، ومخططات استعمار الفضاء وهشاشة الكوكب أمام النزاعات والجشع الذي سيؤدي إلى الفناء لا محالة.
وقد جاء عمل ليسينغ الأخير “الحلم الألذ”، ضمن الأعمال الكثيرة التي أنتجتها، في مجال الرواية والنقد ومجلدين من السيرة الذاتية. كان الأول منهما “تحت جلدي” الذي تحكي فيه عن ميلادها في بلاد فارس، ثم طفولتها في جنوبي روديسيا وبعدها عن عملها كسكرتيرة وربة بيت هناك. وينتهي المجلد الأول عام 1949، عندما غادرت وخلّفت وراءها اثنين من أبنائها الثلاثة الأكبر عمرا، وفرّت من قيود زواج رديء وحياة متعبة في أفريقيا لتنتقل إلى لندن، دون مال تقريبا لكن كانت تحدوها الرغبة في صنع مكانة لنفسها تليق بها وبما تأمل كتابته.
أما المجلد الثاني من سيرتها الذاتية فكان بعنوان “السير بين الظلال”، وتصف فيه سنواتها التي عملت فيها كاتبة قليلة الخبرة، نشرت خلالها روايتها الأهم “الكراسة الذهبية” عام 1962.

ومثل معظم روايات ليسينغ، تنحو “الحلم الألذ” إلى منظومة مذهلة من المواضيع. ويقع قسم كبير من الرواية في مكان يطلق عليه “زيمليا”، وهي بلد أفريقي متخيل، ربما تتكون مقاطعه اللفظية من زامبيا وزيمبابوي، وهو ما يسمح للروائية أن تقوم بفحص الكفاح الأفريقي فترة ما بعد الكولونيالية، وهي التيمة التي لا تمل الكتابة عنها.
أما سيلفيا، وهي واحدة من الشابات التي تؤويها فرانسيس، فتسافر هناك لتأسيس عيادة في تجمع فقير حيث يشحذ الأطفال الكتب، ويموت السكان فيه من مرض غريب.
محطات من السيرة
جاءت رواية “الضحكة الأفريقية” كسيرة ذاتية كُتبت بأسلوب سردي ممتع، تتناول فيه 4 زيارات للدولة الجديدة زيمبابوي، وتحكي عن حقب مهمة عدة لتاريخ تلك الدولة، عندما كانت تُسمى روديسيا الجنوبية، والنضال الذي خاضه المواطنون السود ضد قمع الاحتلال الإنجليزي الأبيض، وما سبقه من احتلال برتغالي. ويُبرز هذا الكتاب أيضًا معاناة المواطنين في أثناء الاحتلال وانضمامهم لصفوف الفدائيين. إنها أسطورة شخصية، تصف فيها دوريس ليسينغ مشاعرها عند العودة، والأماكن التي ما زالت محفورة في ذاكرتها.
وإضافة إلى الأجزاء العديدة التي أصدرتها حول سيرتها الذاتية، أصدرت جزءًا عن سيرة والديها بشكل خاص، بل حتى حول سيرة جارتها في “يوميات جارة طيبة” التي تقول إنها حين أرادت نشرها تحت اسم مستعار، تم رفضها من قبل ناشرها المعتاد، لأنه لم يكن قد عرف أنها هي من كتبتها.

وفي روايتها “ألفريد وإميلي”، أعادت ليسينغ إنتاج طفولتها، وقت أن كانت على بعد سنوات قليلة من نهاية عقدها التاسع، وراحت تعلن أنّها كتبت كتابها الأخير، قبل أن تتراجع وتدفع إلى الناشر بكتاب آخر. وتمكنت ليسينغ بذلك من مفاجأة القرّاء، ليس لأنّها كانت ما تزال قادرة على المشاركة في دورة الحياة فقط، بل لأنها كانت ما تزال تحتفظ بالزمن الطفوليّ باعتباره دافعًا على الكتابة.
وهكذا ظلت دوريس ليسينغ، قادرة على جلب الدهشة، من حيث لا يتوقّع الناس. فقد كانت، مثلما وصفها بيان جائزة نوبل “حكواتية ملحميّة للتجربة التي روتها بزخم وشك ورؤيويّة، غائرة في شرخ الحضارة المقسومة”.

ووقد ظل هذا الانطباع يلازم إبداعها، من رواية “الإرهابية” التي تتناول المرأة البورجوازيّة التي ضجرت من حياتها والتحقت بصفوف “الجيش الأيرلندي الثوري”، إلى رواية “الجدتان” التي تتناول حياة سيدتين ستينيتين تعيش كل منهما قصّة حب مع ابن الأخرى، ومرورا بـروايات “تقرير عن النزول إلى الجحيم”، و”مذكرات ناج”، و”أرشيف كانوبوس في آرغوس”، و”الحب مرّة أخرى”، إلي جانب سلسلة “أطفال العنف” وسلسلة “مارتا كويست”، وصولا إلى “أعذب الأحلام” التي عادت فيها ذكرياتُ عمرها الستيني في قالب روائي. وعلى الرغم من الروح التشاؤمية التي تواصلت في أعمالها، كان واضحا أن هناك خيطا رفيعا من الإرادة الفردية، التي تحاول عبرها، مواجهة آثار وتبعات دمار العالم. تلك الإرادة الصلبة كانت مُسلحة بروح إنسانية، لا تستطيع تغيير الواقع أو رأب الصدع في جسده، ولكنها كانت قادرة على التعايش والبقاء.