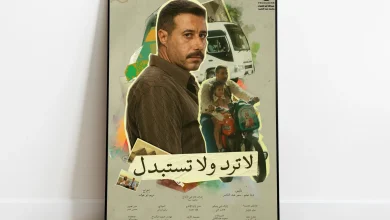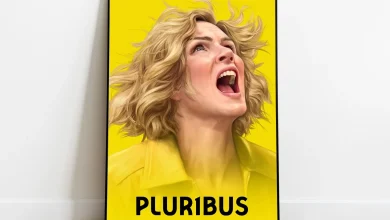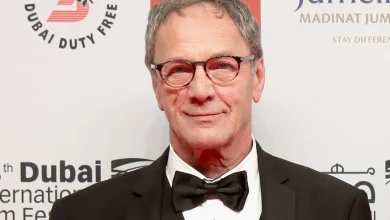الاستشراق الجديد وتحديات التواصل الحضاري في مؤتمر الدوحة الدولي

الدوحة- استضافت العاصمة القطرية المؤتمر الدولي الأول للاستشراق يومي 26 و27 أبريل/نيسان 2025، الذي جمع نخبة من المفكرين والباحثين والمستشرقين والمستعربين جاؤوا من أقطار العالم المختلفة، بهدف توفير منصة أكاديمية وفكرية للنقاش الموضوعي حول واقع الدراسات الاستشراقية، وتحولاتها التاريخية والمعاصرة، ومواقفها المتجددة من قضايا العصر الملحة، وسيرورة التفاعل المعقد بين الشرق والغرب.
ورسم رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر محمود الحمزة صورة بانورامية لتطور مفهوم الاستشراق، مشيرا إلى أنه بدأ كـ”موضوع فكري وثقافي مهم، وله أبعاد سياسية واقتصادية وثقافية” ونشأ قبل قرون وكانت غاياته الأولى تمهيدا للاستعمار. وأوضح كيف أن كتاب “الاستشراق” للمفكر الفلسطيني الأميركي إدوارد سعيد “أحدث هزة في أوساط المستشرقين” بفضح سلبياته وتصويره المنحاز للشرق ككيان “ضعيف لا يقدر على إدارة أموره ويحتاج إلى من يحكمه”.
ومع بزوغ ما يسمى “الاستشراق الجديد” لاحظ الحمزة – في مقدمته لأوراق المؤتمر- ظهور “شيء من الموضوعية عن الشرق” مدعوما ببروز باحثين من أصول شرقية في الأوساط الأكاديمية الغربية، بالإضافة إلى “ظهور التكنولوجيا الحديثة والثورة الرقمية والمعرفية التي انتزعت احتكار الغرب لدراسة الشرق”.
ورغم هذه التحولات، نبه رئيس اللجنة العلمية إلى أن “الاستشراق الجديد لم يختلف من حيث الجوهر عن الاستشراق التقليدي” حيث لا تزال معظم الأبحاث الحديثة “تصب في خدمة جهات حكومية أو شركات اقتصادية كبرى تمول الأبحاث، ولها مصالح واسعة في بلدان الشرق”.
وأكد الدكتور الحمزة على التحديات المستمرة التي تواجه الاستشراق، وعلى رأسها “ضرورة استقلالية المراكز البحثية الاستشراقية عن التسييس وإعطائها فرصة لتقديم تحليلات علمية موضوعية واقعية تخدم التقارب بين الحضارات وتخلص الفكر الغربي من النزعة المركزية الأوروبية”. وانتقد المقولات الاستشراقية القديمة في ضوء تفوق دول مشرقية اليوم، لافتا إلى ازدواجية الغرب الذي “يتحدث عن الحرية والقيم والحضارة، ولكنه يدعم الاحتلال الصهيوني في إبادة الشعب الفلسطيني”. وخلص إلى أن المؤتمر يسعى إلى “انتشال الاستشراق من دائرة التوترات الأيديولوجية والتحيزات المسبقة إلى دائرة البحث العلمي الجاد الذي نطمح أن يؤسس لتواصل بناء بين المجتمعات الإنسانية”.
المؤتمر يسعى إلى انتشال الاستشراق من دائرة التوترات الأيديولوجية والتحيزات المسبقة إلى دائرة البحث العلمي الجاد الذي نطمح أن يؤسس لتواصل بناء بين المجتمعات الإنسانية
أشكال ومناهج الاستشراق
وقد غطت أوراق العمل المقدمة طيفا واسعا من القضايا المحورية، عاكسة ثراء النقاش وعمقه. ففي محور “أشكال الاستشراق الجديد واتجاهاته ومناهجه” أوضح البروفيسور شاه رستم غياث شاه موساروف أستاذ العربية بجامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية كيف انتقل الاستشراق من الدراسة الأكاديمية الاستعلائية إلى الاهتمام بقضايا السياسة والاقتصاد والمجتمع، لكنه لا يزال متأثرا بالمصالح الغربية. ومن جانبه، قدم الدكتور عاصم حفني المستشار الأكاديمي والمحاضر بجامعة ماربورج نماذج ألمانية تسعى إلى “إزالة الاستعمار من المعرفة وتفكيك الاستشراق القديم والجديد” عبر نقد المركزية الأوروبية وإشراك الشرق كـ”فاعل معرفي بعد أن كان مفعولا به”.
وفي سياق متصل، تناولت ورقة الأكاديمي والكاتب الهندي الدكتور زين العابدين كوكانتشيري تحول الاستشراق في الهند إلى أداة إلى “شيطنة المسلمين عبر تصويرهم بوصفهم إرهابيين أو مهددين للاستقرار الاجتماعي” داعيا إلى مواجهة “التشويه الغربي للإسلام واستعادة السردية الحقيقية”. وتساءل الباحث المستقل الدكتور مازن صلاح مطبقاني عن حقيقة حداثة “الاستشراق الجديد” مشيرا إلى أن متابعة النتاج البحثي والمؤتمرات تظهر استمرار موضوعات الاستشراق التقليدي “وكأن الاستشراق القديم والحديث شيء واحد”.
وبدورها، أكدت الدكتورة فاطمة محمود إغبارية رئيس المجلس الأكاديمي الأعلى بكلية النساء للآداب والعلوم بكيرالا الهندية أن الاستشراق الجديد يتعامل مع الشرق كأنه “عدو” وهو “أكثر ترسخا، ومتعدد الأوجه، ومضرا أكثر من سابقه، لقد تحول إلى ما يطلق عليه اليوم الإسلاموفوبيا”. ومن البلقان تحدث الأكاديمي البوسني الأستاذ الدكتور ميرزا سارا يكتش محللا الاستشراق الصربي الذي تطور إلى نموذج يسعى إلى “نفي الهوية البوسنية اللغوية والثقافية بالجملة والإنكار المؤسسي لجريمة الإبادة الجماعية في سربرنيتسا” وناقش سارا يكتش تحول ذلك النموذج من الاستشراق من “المعرفة الزائفة” إلى “نموذج سياسي حيوي” يبرر التمييز وإنكار الهوية.
ومن النرويج، استعرضت مديرة مركز مينوتنك ليندا نور المعضلة التي يواجهها الفاعلون في المجتمع المدني المسلم أمام “خطابات الاستشراق الجديد” التي تصورهم معارضين للقيم الغربية وتدفعهم باستمرار لإظهار الولاء لتجنب “الإقصاء والتهميش”.
وقدم الصحافي والكاتب السوري عبد الرحمن مظهر الهلوش دراسة نقدية لأشكال الاستشراق الجديد، مؤكدا أنه “رغم محاولات التجديد لا يزال الاستشراق الجديد يحمل تصورات غربية مسبقة مما يستدعي نقدا دقيقا وإنتاج معرفة أكثر استقلالية من داخل المجتمعات الشرقية نفسها”. وبحث الدكتور حيدر قاسم مطر التميمي رئيس قسم الدراسات التاريخية ببيت الحكمة في بغداد في “متلازمة الصراع الحضاري” وتأثيرها على تحول الدراسات الاستشراقية نحو الواقع المجتمعي والتطورات السياسية، مع انفتاح الباب أمام تخصصات كالاجتماع والأنثروبولوجيا والاقتصاد.
ولم يغب عن خلاصة أعمال المؤتمر التأكيد على أن الاستشراق الجديد، مهما تجمل بخطابات التنوع والانفتاح، لا يمكن فصله عن سياق صراعات القوى العالمية، وأن فهمه يتطلب قراءة شاملة تجمع بين التحليل المعرفي والنقد السياسي. ودعت بعض التوصيات إلى تعزيز تدريس مناهج نقد الاستشراق بالجامعات العربية، وتوسيع شبكات البحث والتعاون مع أصوات نقدية في الغرب نفسه، خصوصا التي ترفض السرديات الاستعلائية وتؤمن بالشراكة الحضارية الحقيقية.
الدراسات العربية والإسلامية
وفي محور “الاستشراق والدراسات الإسلامية والعربية” استعرضت مؤرخة العلوم المتقاعدة الدكتورة سونيا برينتس التغيرات في تاريخ العلوم بالمجتمعات الإسلامية، والتشكيك في مواقف سابقة حول انحطاط هذه المجتمعات المزعوم أو العداء المبدئي للعلماء فيها. ودافع الباحثان المجريان الدكتوران كينغا ديفيني وتماش إيفاني عن تراث المستشرقين وأكدا أنه “لا يمكننا قبول الفكرة القائلة إن المستشرقين الأوائل تعمدوا تشويه الحقائق أو خدموا القوى الاستعمارية فقط” وأن الجيل الجديد يتناول القضايا بـ”موضوعية أكبر”.
وناقش رئيس كرسي الإيسيسكو لحوار الحضارات الدكتور عز الدين معميش ضرورة دراسة تحولات “الاستشراق الجديد” لفهم “معالم التفسيرات والرؤى الجديدة المرتبطة بعالمنا الإسلامي” وكشف “هوامش التداخل بين المعرفة والسلطة”. وحلل العميد السابق لكلية دار العلوم جامعة القاهرة الدكتور عبد الراضي محمد عبد المحسن رضوان أزمة “الاستشراق المخضرم” الذي وجد نفسه عالقا بين سرديات القديم وتيارات الجديد التي “فككت الإسلام وتاريخه بمنهجية تلفيقية لتجعله أساسا لكل مشكلات العالم المعاصر وعدو الغرب الآني والمستقبلي”. وتناول أستاذ العقيدة والأديان الدكتور عبد القادر بخوش تميز الاستشراق الفرنسي الجديد باعتماده على العلوم الاجتماعية والأنثروبولوجيا، وابتعاده “جزئيا عن المركزية الأوروبية والصور النمطية”.
وانتقد الدكتور ماهر عبد القادر محمد علي المتخصص في فلسفة العلوم بجامعة الإسكندرية الاستشراق الغربي الذي كان “في خدمة الاستعمار في كثير من الأحيان” معتبرا أن “اختراق الاستشراق الجديد أيديولوجيا لمجتمعاتنا العربية الإسلامية يمثل تحديا حضاريا للذات”. وأكد أستاذ التعليم العالي بجامعة بادوفا الإيطالية الدكتور محمد خالد براند اليزي الغزالي أن تأثير الاستشراق الجديد يصيب حتى الخطاب العلمي، مما يغذي “نماذج العلاقات غير النقدية والمتماثلة” ويساهم في “الإسلاموفوبيا البنيوية”.
ومن جهته، رأى الباحث في الدراسات الإسلامية بجامعة لندن حسن عبد الله الرميحي أن التركيز على “التمثيل” في نقد الاستشراق أغفل “البنى المعرفية والسياسية التي جعلت من التمثيل أداة للهيمنة” وأن المطلوب هو “إصلاح الأسس المعرفية التي أنتجت هذه الصورة” بدلا من محاولة تحسينها. وتساءل أستاذ الفكر الغربي بجامعة قطر الدكتور عمر بن بوذينة “كيف انتقل الاستشراق من الأيديولوجيا الاستعمارية إلى فضاء للصلح الحضاري؟” محللة دور مدارس ما بعد الاستعمار والفكر ما بعد الحداثي في تفكيك التصورات الاستعمارية.
وفي الدراسات القرآنية تحديدا، قدم أستاذ النقد بجامعة البحرين الدكتور أحمد محمد ويس تأملات في منجز المستشرقة الألمانية أنجليكا نويفيرت وجهودها الكبيرة ومركزها البحثي، مشيرا إلى أنها تعرض القرآن بوصفه “كتابا تنويريا ظهر في سياق تاريخي مضطرب وفي منطقة تعج بالنقاشات الدينية” دون أن تتبنى رأيا واضحا في قضايا الوحي. وانتقد الدكتور أحمد خان الأستاذ المساعد بالجامعة الأميركية بالقاهرة المنهجيات الحديثة لإهمالها “الإسهامات العلمية والتفسيرية للمسلمين” داعيا إلى “هرمنيوطيقا بديلة”. وتتبع الدكتور سامر رشواني الأستاذ المشارك بجامعة حمد بن خليفة تطور دراسة بنية السورة القرآنية في الغرب من النقد التاريخي إلى الأدوات الأدبية والبلاغية. وراجع الدكتور معتز الخطيب الأستاذ المشارك بجامعة حمد بن خليفة النقد الغربي للمرويات الحديثية، معتبرا أنه قدم نفسه كـ”بديل موثوق عن علوم الحديث” وأثار “الشكوك حول صحة الحديث ومدى كفاية منهج المحدثين”.
قضايا الاستغراب والمرأة
وأشار الدكتور عمرو عثمان الأستاذ المشارك بجامعة قطر إلى بروز جيل جديد من الباحثين في الفقه الإسلامي، مسلمين وغير مسلمين، يقدمون “خطابا يبدو مختلفا عن الخطاب القديم” مما يدفع “إما إلى إعادة تعريف الاستشراق، أو التخلي عن هذا المفهوم تخليا كليا”. وناقش الدكتور عبد الرحمن حللي الأستاذ المشارك بجامعة قطر ظاهرة “اللاهوت الإسلامي في ألمانيا” وكيف أصبحت “موضوع جدل سياسي وأكاديمي لم ينته”. وقدم الأستاذ الدكتور إدريس نغش الجابري أستاذ فلسفة العلوم بجامعة القرويين قراءة إبستمولوجية للتقليد العلمي في الإسلام مقارنا بين رؤى الاستشراق الكلاسيكية والمعاصرة حول نشوئه وتوارثه. ورصد الأستاذ الدكتور أحمد السري أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة صنعاء صدى الاستشراق الجديد في كتابات عربية تشتبك معه، خاصة في الموقف من القرآن. وأوضح الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد المفتي العام لأستراليا كيف استخدم الاستشراق “أداة للاستعمار” لتقديم “الإسلام بوصفه تهديدا لا هداية” مع الإشارة إلى ظهور تيارات حديثة “نأت بأنفسها عن المناهج الاستشراقية التقليدية”. وتساءل الباحث السويدي الدكتور يان هنيغسون -مستشهدا بالعروي وحنفي- عن جدوى اتخاذ أعمال المستشرقين منطلقا لتحليل الثقافة العربية، مشيرا إلى أهمية “علم الاستغراب” كمنهج لدراسة الغرب.
أما محور “الاستشراق والمرأة المسلمة” فقد شهد مداخلات مهمة، حيث رأت الدكتورة فاطمة صديقي أستاذة اللسانيات بجامعة حمد بن خليفة أن خطاب الاستشراق غالبا ما يصور النساء العربيات إما “ضحايا صامتات وإما رموزا للمقاومة” ويعزز “مهمة الإنقاذ” الغربية، في حين تقاوم العربيات ذلك بتقديم “تمثيلات أكثر أصالة لحياتهن”. وسلطت المستشرقة البلغارية الأستاذة الدكتورة بيان ريحانوفا الضوء على ازدهار الأدب العربي واهتمام المستشرقات بدراساته وترجماته، مستشهدة بأعمال كيربيتشنكو وكيلبتريك. واستعرضت الأستاذة طرفة المنصوري الباحثة بمركز المجادلة للمرأة تطور “المهمة الحضارية” من مبرر للاستعمار إلى “الحرب على الإرهاب” التي استخدمت مسوغات جديدة للتوسع العسكري وتزامنت مع “شيطنة العرب والمسلمين” في الإعلام الأميركي. وحللت الأكاديمية السعودية الدكتورة ملاك إبراهيم محمد الجهني أثر نظرية المعرفة الغربية في الدراسات الإقليمية التي “تهمش إبستمولوجيات الجنوب العالمي” وتعيد إنتاج التصورات النمطية عن المرأة المسلمة.
فلسطين والذكاء الصناعي
وفي المحور الخاص بـ”الاستشراق وفلسطين” أوضح الدكتور نزار أيوب المحامي بالجولان المحتل كيف استمدت الصهيونية رؤيتها من الاستشراق من أجل “نزع صفة الإنسانية” عن الفلسطينيين وتشبيههم بـ”الحيوانات والمتخلفين” وهو ما تجلى في تصريحات القادة الإسرائيليين خلال حرب غزة الأخيرة مثل وصف وزير الدفاع للسكان بأنهم “حيوانات إنسانية”. وبين الأستاذ الدكتور عصام نصار مؤرخ فلسطين كيف ركز الاستشراق التوراتي الإنجيلي على التاريخ الديني لفلسطين، مختزلا إياها في “موقع ديني، وغالبا ما كان يمحو سكانها الأصليين مع التركيز على التراث الأوروبي واليهودي” خدمة للأهداف الاستعمارية. وحذر الدكتور أورهان الماس الباحث بجامعة سنت أندروز من “الاستشراق الرقمي” الذي يعيد تشكيل المنطق الاستشراقي عبر الخوارزميات وأنظمة معالجة اللغة التي قد تجعل “الخطاب العربي خاصة السياسي أو المقاوم مشبوها بشكل تلقائي”. وحلل الدكتور بدران بن الحسن مدير مركز ابن خلدون بجامعة قطر استمرار تأثير الخطاب الاستشراقي الثنائي الذي يصور “الغرب عقلانيا ومتحضرا مقابل تصوير العرب عامة والفلسطينيين خاصة باعتبارهم عنيفين وغير عقلانيين” في تبرير الدعم الغربي لإسرائيل وتهميش الرواية الفلسطينية خلال حرب غزة.
وبين مداخلات العارفين بتجربة الاستشراق القديمة، وطموحات الباحثين عن طريق ثالث بين التغريب والانغلاق، ظل الحلم قائما بأن يتحول مؤتمر الدوحة إلى محطة تأسيسية، تعيد الاعتبار للذات العربية والإسلامية بوصفها طرفا فاعلا في إنتاج المعرفة، لا مجرد موضوع للدرس.
كما تطرق المؤتمر إلى “الاستشراق والثورة الرقمية” حيث قارن الأستاذ المساعد بالهند الدكتور عبد الغفور الهدوي كوناتودي بين تمثيلات الإسلام والعرب في نماذج الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن “الاستشراق لم يعد محصورا في الخطاب الأكاديمي التقليدي، بل أصبح جزءا من الذكاء الاصطناعي أيضا”. وقدم مؤرخ العلوم المغربي الأستاذ الدكتور محمد أبطوي دفاعا عن أفضلية التقليد النصي العربي لكتاب إقليدس، منتقدا إعراض المحققين الغربيين عن المخطوطات العربية التي اعتبرها “أكثر إخلاصا للأصل”.
وأشارت الأستاذة مريم عبد الغني حسن صالح الباحثة بجامعة البحرين إلى الكيفية التي مكنت التقنيات الرقمية من تحليل النصوص الاستشراقية بدقة غير مسبوقة وكشف الأنماط المتكررة، وفي المقابل مكنت المجتمعات الشرقية من “إعادة تقديم ذاتها، بعيدا عن التصورات الاستشراقية التقليدية”. وتناول الدكتور آرشين أديب مقدم الأستاذ بجامعة لندن مفهوم “الاستشراق التقني” وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن “يكرس للهرميات العرقية والثقافية” داعيا إلى “نهج تحولي في تطوير الذكاء الاصطناعي يكسر هذه الهياكل الهرمية الراسخة”.
الأدب ومدارس الاستشراق
وفي علاقة “الاستشراق بالأدب” كشف الدكتور بيتر ويب المحاضر بجامعة لايدن عن لقاءات ثقافية مبكرة منسية بين الشرق والغرب تعود للقرن الـ17، سابقة لمفهوم الاستشراق المتعارف عليه. واعتبرت الدكتورة فدوى الهزيتي العبار الأستاذة بجامعة الحسن الثاني الاستعراب الإسباني وجها آخر للاستشراق نشأ في كنف إسبانيا الحديثة ولعب “دورا مؤسسا في تشكيل صورة المسلم لدى الأوروبيين” ورغم تحوله إلى “استعراب ناعم” إلا أنه “لم يتجاوز ارتدادات السرديات الاستشراقية السائدة”.
وأكد أستاذ الفن الإسلامي بجامعة غرناطة الدكتور خوسيه ميغيل بويرتا فلتشز خصوصية الاستعراب الإسباني الذي تنصب أغلب دراساته على الأندلس، مشيرا إلى قول إدوارد سعيد بأن “علاقة إسبانيا مع الإسلام علاقة تكاملية حميمة، داخلية وليست خارجية”. وقدمت الباحثة والمترجمة المصرية الدكتورة دينا فتحي مندور مفهوم “أدب ما بعد الاستشراق” متسائلة “إذا كان هذا هو الشرق -كما ابتدعه الغرب- فما حال الشرق في عيون الشرقيين؟” من خلال تحليل كتابات الروائيين الشرقيين المتغربين في فرنسا.
وفيما يخص “الدراسات العربية” استعرضت مديرة مركز دراسات آداب البلدان العربية بجامعة طشقند الحكومية الدكتورة هاللة عبد الحي يولداشيفا تاريخ ومناهج تدريس العربية في أوزبكستان، مشيرة إلى الحاجة إلى “اعتماد طرق تعليم مبتكرة تركز على تنمية مهارات التواصل واستخدام الوسائل التقنية”. وقدم الأستاذ روالن الفيت رئيس الجمعية الفرنسية للدراسات المعجمية تحديثا حول دراسات الكلمات الدخيلة من العربية في فرنسا، معتبرا أن هذا النشاط يشكل “مساهمة في الاستشراق الجديد، أكثر تركيزا على الجانب العلمي”. وقارنت الدكتورة نينو إيجيبادزه الأستاذة المشاركة بجامعة تبليسي الحكومية بين منهجي وصف العربية، العربي التقليدي والغربي، مقترحة إمكانية “توليف المنهجين من حيث سهولة توصيل المعلومات”.
وأكدت أستاذة العربية بجامعة حمد بن خليفة الدكتورة بسمة أحمد صدقي الدجاني أن “حركة الاستشراق خلال القرن الأخير أدت إلى زيادة انتشار اللسان العربي غربا” ونتج عنها “حالة من استكشاف الذات التي تتضح بالتفاعل وانعكاس الصورة في عيون الآخر”. وانتقد المستعرب واللغوي الفرنسي الأستاذ الدكتور جوزيف ديشي مفهوم “الازدواجية اللغوية” الزائف المطبق على العربية، مقترحا مفهوم “تعدد الملاسن” الإدراكي الأكثر مرونة. وناقش كل من الدكتور منتصر الحمد الأستاذ بجامعة قطر والدكتور أشرف عبد الحي الأستاذ المشارك بمعهد الدوحة كيف تأثر تدريس العربية كلغة أجنبية في الغرب بالتصورات الاستشراقية التي اختزلتها في “سياقات تراثية جامدة” أو ربطتها بالبعد الديني وألحقتها بأقسام الدراسات الشرقية. ومن تجربته في الصين، رأى الدكتور داود إبراهيم ذيب عبد الله الباحث بجامعة صون يات سن أن الاستعراب في الصين “نموذج مختلف” له دوافعه ومنطلقاته الخاصة، وأنه “استعراب على الطريقة الصينية” مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود معوقات في تعليم العربية هناك.
واستعرض المؤتمر “مدارس الاستشراق” المختلفة، حيث تحدث الأستاذ الدكتور نادر عبد الحي نائب رئيس جامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية عن تاريخ وحاضر ومستقبل الاستشراق في أوزبكستان. وميز الدكتور شوي تشينغ قوه بسام أستاذ الدراسات العربية بجامعة الدراسات الأجنبية في بكين بين الاستشراق الشرقي (الصيني العربي) والغربي، فالأول ينطلق من “منظومة قيمية متشابهة” و”مسار تاريخي متشابه” ويهدف إلى “اعتبار هذا الآخر مرآة للتعرف على الذات بشكل أحسن”. وعرض الدكتور علي فرج أستاذ العربية بجامعة ميالنو-بيكوكا دور مكتبة أمبروزيانا ومستشرقيها في الدراسات الإسلامية والعربية الحديثة. وتناول الدكتور ناصيف مانابيالنغ أديونغ مدير هيئة انتقال بانغسامورو “الاستشراق الفلبيني” واستهدافه لأقلية البانغسامورو المسلمة، وردود فعلهم المتمثلة في “الحكم الأخلاقي” و”إزالة الاستعمار”.
تجديد المعرفة
وطرح الباحث المستقل الدكتور أتسوشي أوكودا (كمال) مفهوم “الاستشراق الإسلامي” الداخلي الذي يعكس تقسيمات الاستشراق التقليدي، داعيا لتجاوزه عبر “تجديد المعرفة، وإصلاح التعليم، وتغيير الخطاب الديني”. وتتبع المترجم الدكتور محمد حقي صوتشين الباحث بجامعة غازي بأنقرة أثر الاستشراق الألماني في تأسيس الدراسات العربية الحديثة في تركيا وانتقالها للمجال الأكاديمي. ودعا الأستاذ بجامعة أوتونوما بمدريد الدكتور إغناطيوس غوتيريث دي تيران غوميث بينيتا إلى تجديد الدراسات الاستشراقية الأوروبية لتواكب المستجدات، مؤكدا على دور “الاستعراب الإسباني التجديدي” بناء على التجربة الأندلسية. ورصدت الباحثة بجامعة السلطان قابوس صفاء بن عبد المومن تحولات الاستشراق الإسباني بعد 11 سبتمبر/أيلول (عام 2001) نحو القضايا المعاصرة كالإسلام السياسي والتطرف.
وعرض الأستاذ بجامعة داغستان الحكومية زمير زاكارياييف خصوصيات مدرسة داغستان الاستشراقية وتميزها بمشاركة علماء مسلمين. وأوضح رئيس قسم العربية بجامعة داغستان الحكومية الدكتور محمدوف أزرت أحمدوفيتش تطور الدراسات الشرقية في داغستان ودور جامعته في العصر الحديث. ودرس الباحث بجامعة السلطان قابوس الدكتور رشاد حسنوف خصائص الاستشراق الأذربيجاني الحديث وتحرره التدريجي من التأثيرات الأوروبية والروسية.
وفرّق الدكتور فلوريال سناغوستان الأستاذ بجامعة ليون تطور الاستشراق الفرنسي، بين “الدراسات الجدية المعمقة” والمقالات السطحية ذات الطابع الأيديولوجي، مؤكدا ضرورة نشر الأبحاث المتخصصة “لإطلاع جمهور القراء على الحقيقة العلمية”. وعرضت الدكتورة يون أون كيونغ رئيسة قسم العربية بجامعة هانكوك وضع الدراسات العربية والإسلامية في كوريا الجنوبية، مشيرة إلى تميزها بـ”مناقشة الإسلام من منظور أكاديمي من أجل تعريف القراء الكوريين بخصائص الإسلام بشكل صحيح وموضوعي”.
وهكذا أغلقت الجلسات أبوابها، وفتحت الأسئلة الكبرى لإعادة التفكير في قراءة نقدية لتاريخ ومستقبل هذا الحقل المعرفي الشائك. وبينما كشفت المداخلات عن استمرارية التحديات المنهجية والأيديولوجية الموروثة، فإنها أبرزت في الوقت ذاته حيوية النقاش وظهور مقاربات جديدة تسعى نحو فهم أعمق وتواصل أكثر توازنا بين الحضارات، بعيدا عن منطق الهيمنة والصور النمطية.